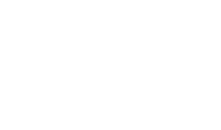-
۱۵۱
الخروج كان تكليفآ بالمحال. وبكلمة أخرى، لو لم يكن يتمكّن العبد من الإمتثال فلا يكون أمر في البين حتّى يتنازع في إجتماعه مع النهي؛ لأنّ الصلاة في المغصوب ليست مورد الأمر، والصلاة المطلقة غير مقدورة، فلا بدّ من وجود المندوحة حتّى لا يلزم التكليف بالمحال المستتبع للتكليف المحال مع الإلتفات والتوجه، كما هو الظاهر.[1]
هذا، وقد يعترض عليهم السيّد الإمام (قدس سرّه) ويقول :
الظاهر إنّ ما ذكروا من توهّمُ إعتبار المندوحة إنّما نشأ من خلط الأحكام والخطابات الكلّية القانونية بالأحكام والخطابات الجزئية والشخصية، مع أنّه قد أشرنا غير مرّة إلى أنّ لكلّ منهما ملاكآ وضابطةً تخصّه؛ بداهة إعتبار إحتمال الإنبعاث في الخطاب الشخصي بالنسبة إلى المخاطب، وعدم إعتبار ذلک في الخطاب القانوني؛ فإنّ المعتبر في جعل الأحكام القانونية، هو إنبعاث أو إنزجار طائفة منهم في الأعصار والأمصار، ولا يعتبر فيها ملاحظة حالات كلّ واحد من الأفراد مع ما هم عليه من الإختلاف؛ فبعضهم عاجز، وبعضهم جاهل... إلى غير ذلک من الأعذار، وغاية ما يقتضيه العقل عند طروّ الجهل أو العجز أو غيرهما، هي معذورية المتلبّس بها، لا تقييد الحكم بعدمها، فإذا تعلّق الحكم بعنوان وإبتلى الشخص بأعذار منها إبتلاؤه بعدم القدرة عليه بلحاظ إنطباق عنوان حكم آخر عليه لا يصير الحكم إنشائيآ، بل فعليآ، وغاية ما يقتضيه حكم العقل هي معذورية الشخص عن القيام بإمتثال الحكم الفعلي. والسرّ في ذلک هو عدم إنحلال التكليف الواحد بعدد رؤوس آحاد المكلّفين حتّى يكون كلّ فرد مخصوصآ بخطاب يخصّه، حتّى يستهجن خطابه بالبعث نحو الصلاة مثلاً، وبالزجر عن الغصب، حتّى يصير المقام من التكليف بالمحال، أو التكليف المحال
1 ـ تحريرات في الأصول :4 177.
-
۱۵۲
من المولى الحكيم، بل تكليف واحد بإرادة واحدة؛ وهي إرادة التشريع وجعل الحكم على العنوان ليصير حجّة على كلّ من أحرز دخوله تحت العنوان.[1]
فعلى هذا نقول: العنوانان اللّذان تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي، إمّا غير مرتبطين ويفترق كلّ منهما عن الآخر بحسب نوع حالات المكلّفين في الأعصار والأمصار، كعنواني الصلاة والغصب، حيث إنّ عامّة الناس في الأعصار والأمصار، يتمكّنون غالبآ من إتيان الصلاة في غير الدار المغصوبة، نعم ربّما يتّفق لبعضهم ويتضيّق عليه الأمر نادرآ، بحيث لا يتمكّن إلّا من الصلاة في الدار المغصوبة؛ وإمّا أن يكونا متلازمين وغير منفكّين بحسب التحقّق الخارجي.
إذا فرضنا أنّ العنوانين من قبيل القسم الثاني أي متلازمين وجودآ بحيث لا ينفکّ أحدهما عن الآخر في جميع الأمكنة والأزمنة وعند جميع المكلّفين ممّن غبر أو حضر، فالبعث إلى أحدهما والزجر عن الآخر مع كون حالهما ذلک مما لا يصدر عن الحكيم المشرّع بل من غيره؛ لأنّ الإرادة الجدّية إنّما تنقدح في مورد يقدر الغير على إمتثاله، وعند التلازم في الوجود كان التكليف محالا لأجل التكليف المحال، فضلا عن كونه تكليفآ بالمحال ومعه لا يلزم التقييد بالمندوحة.
وأما إذا فرضنا أنّهما من قبيل القسم الأوّل، أي غير مرتبط أحدهما بالآخر في الوجود الخارجي غالبآ، وإنّما يتصادقان أحيانآ، وإنّ عامة الناس يتمكّنون من إتيان الصلاة في غير الدار المغصوبة غالبآ، وإنّه لو ضاق الأمر على بعضهم بحيث لم يتمكّن إلّا من الصلاة في الدار المغصوبة، لكان من القضايا الإتفاقية التي يترقّب زوالها، فلا حاجة إلى إعتبار المندوحة لما قد حقّقنا أنّ الأحكام الشرعية لا تنحلّ إلى خطابات بعدد الأفراد حتّى يكون كلّ فرد مخصوصآ بخطاب خاص فيستهجن الخطاب إليه بالبعث نحو الصلاة والزجر عن الغصب، ويصير المقام من التكليف بالمحال أو التكليف المحال، بل معنى عموم الحكم وشموله قانونآ هو
1 ـ جواهر الأصول :4 40.
-
۱۵۳
جعل الحكم على عنوان عام مثل المستطيع يجب عليه الحجّ، ولكن بإرادة واحدة وهي إرادة التشريع وجعل الحكم على العنوان، حتّى يصير حجةً على كلّ من أحرز دخوله تحت عنوان المستطيع، من دون أن يكون هناک إرادات وخطابات وحينئذ فالملاک لصحّة الحكم الفعلي القانوني هو تمكّن طائفة منهم من إتيان المأمور به، وإمتثال المنهي عنه لا كلّ فرد فرد. وعجز بعض الأفراد لا يوجب سقوط الحكم الفعلي العام بل يوجب كونه معذورآ في عدم الإمتثال.
والحاصل، أنّه إن أريد بقيد المندوحة حصول المندوحة لكلّ واحد من المكلّفين فهو غير لازم؛ لأنّ البحث في جواز تعلّق الحكمين الفعليين على عنوانين ولا يتوقّف ذلک على المندوحة لكلّ واحد منهم؛ لأنّ الأحكام المتعلّقة على العناوين لا تنحلّ إلى إنشاءات كثيرة حتّى يكون الشرط تمكّن كلّ فرد بالخصوص.[1]
الجهة السادسة: تصحيح الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
قد تقدّم أنّ المراد من الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشکّ في حكم شرعي مسبق، بينما المقصود بالحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه واشترط فيه الشکّ في حكم شرعي مسبق.
ثمّ إنّ ترشّح الإرادة الواقعية الجدية بالنسبة إلى الحكم الواقعي، وترشّح الإرادة الجدّية الأخرى بالقياس إلى إمضاء أو تأسيس ما يؤدي إلى خلاف الإرادة الأولى، مع الإلتفات إلى التخلّف المزبور غير معقول، ففي جميع موارد الأمارات والأصول لا يعقل ذلک، ويلزم بإعتبار آخر ونظر ثان إجتماع النقيضين، فإنّ من إيجاب العمل بالطرق والإرتضاء بإمضاء الأمارات وجعل الحجية يلزم
1 ـ تهذيب الأصول :1 301.
-
۱۵۴
ـتبعآ لهذه الإرادة إنتفاء الإرادة الإيجابية والتحريمية النفسيّة الأولية، فلازم الجمع بينهما وجودها وعدمها؛ كما أنّ ارتفاع النقيضين ظاهر حديث الرفع، فإنّ مقتضى الإشتراک وجود الإرادة التحريمية بالنسبة إلى ملاک الجاهل، ومقتضى حديث الرفع عدمها، فلا بدّ من حلّ ذلک، ولأجله إتخذ كلّ منهم مهربآ وطريقآ.[1]
ولكن يمكن التفصّي عن الإشكال عبر التمسّک بالخطابات القانونية، كما أجاب عنه ولده الشهيد مصطفى الخميني(رحمه الله) في التحريرات وقال :
إنّ من الممكن حلّ هذه الغائلة من ناحية الخطابات القانونيّة، وإن خفي الأمر على مؤسّسها وذلک أنّ الخلط بينها وبين الشخصيّة أوقعهم في هذه المخمصة والمشكلة، وأنّ الخطاب القانونيّ يحمّل التكاليف الفعليّة على كافّة الأنام، ولو كان الأفراد والآحاد عاجزين ما داموا، وجاهلين ما عاشوا. وعليه إتضحت مادّة المغالطة والغائلة، وأنّ الإشتراک ممكن وتواتر الأخبار والإجماع على الإشتراک ليس على ما لا يعقل ثبوتآ، بل هو على ما يعقل وواقع إثباتآ بمراجعة القوانين العرفيّة في مختلف الميادين.
إذا تبيّنت هذه المقدّمة الوجيزة، يظهر حلّ الغائلة فيما نحن فيه؛ فإنّ الشرع والمقنّن إن كان يترشّح منه الرضا والإمضاء في باب الأمارات والطرق، وما يشبهها ـكالأصول المحرزة والأمارة التأسيسيّة أحيانآ بالنسبة إلى خصوص صورة الخطأ، وكان ينحلّ قانون إمضاء الطرق والأمارات وتلک الأصول إلى الأحكام الطريقيّة الشخصيّة، ينقدح الإشكال: بأنّه كيف يمكن أن يرتضي المولى بتطرّق خبر الواحد الخاطئ بالنسبة إلى زيد، مع علمه بأنّ زيدآ محكوم بوجوب صلاة الجمعة، فهل يعقل وجود تلک الإرادة الإلزاميّة الوجوبيّة، مع الإرتضاء وإمضاء سلوكه ذلک الطريق المخطئ؟! فإنّ إنحلال هذا القانون إلى الإمضاءات و الارتضاءات الجزئيّة الشخصيّة، يوجب هذه المعركة.
1 ـ تحريرات في الأصول :6 242.
-
۱۵۵
وأمّا بناءً على المحافظة على تلک القوانين الكلّية على نهج كلّي قانونيّ، وأنّ الإرادة تعلّقت بضرب القانون النفسيّ والطريقيّ، فالنفسيّ عامّ يشمل الكلّ من غير إنحلال إلى الأشخاص، وهكذا الطريقيّ ففي مواقع الإصابة يكون الإمضاء والارتضاء القانونيّ موجودآ، ويكون الطريق حجّة منجّزة. وهكذا في موارد الخطأ يكون الطريق حجّةً معذّرةً، ولا تختصّ الحجّية بصورة الخطأ، أو بصورة الإصابة، بل الحجّية مشتركة، وإلّا فلا يكون حجّةً ومنجّزآ ومعذّرآ، لأنّ التنجيز والتعذير فرع إرتضاء الشريعة به.
وبالجملة تحصّل: أنّ تمام المشكلة ناشئة من ملاحظة الإرادة الشخصيّة في ناحية القانون النفسيّ، وملاحظة الإمضاء الجزئيّ في ناحية القانون الطريقيّ، وحيث إنّ في موارد الخطابات النفسيّة، يكون الناس مختلفين بحسب القدرة والعجز، والعلم والجهل، ويكون الحكم فعليّآ بالنسبة إلى الكلّ، لعدم إختصاص الخطاب بعنوان «العاجز والجاهل» كذلک في مورد إمضاء الطرق العقلائيّة، تكون جميع الطرق بالنسبة إلى كافّة الناس، ممضاة بإمضاء واحد، أو يكون كلّ واحد من الطرق مرضىَّ العمل، و ممضيّآ بإمضاء يخصّه. ولكن في موارد الإصابة والخطأ، لا يكون إمضاء وإرتضاء مخصوصآ بهما، بل الطرق أو خبر الثقة بعنوانه ممضى ومورد الإرتضاء، وعندئذ لا يلزم إمتناع، لعدم الإنحلال في ناحية الخطاب.[1]
الجهة السابعة: تصحيح المعني الحقيقي للرفع وعموميته
قد وقع البحث في مفاد «الرفع» الوارد في رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رسول الله (صلي الله عليه وآله) وهي: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ
1 ـ تحريرات في الأصول :6 251 253.
-
۱۵۶
وَمَا لاَ يَعْلَمُونَ وَمَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَالْحَسَدُ وَالطِّيَرَةُ وَالتَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْق مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ».[1]
هل الرفع في هذا الحديث بمعناه الحقيقي وهو إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه، أو هو بمعنى الدفع أي المنع عن تقرر الشيء وتحقّقه عند وجود مقتضيه، فاستعمل في المقام مجازآ؟
قد أفاد المحقّق النائيني(رحمه الله): أنّ الرفع في الأشياء التسعة بمعنى الدفع، مضافآ إلى أنّ إستعمال الرفع مكان الدفع ليس مجازآ، ولا يحتاج إلى عناية أصلا؛ فإنّ الرفع في الحقيقة يمنع ويدفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق؛ لأنّ بقاء الشيء كحدوثه يحتاج إلى علّة البقاء، فالرفع في مرتبة وروده على الشيء إنّما يكون دفعآ حقيقةً بإعتبار علّة البقاء، وإن كان رفعآ بإعتبار الوجود السابق، فإستعمال الرفع في مقام الدفع لا يحتاج إلى علاقة المجاز، بل لا يحتاج إلى عناية أصلا، بل لا يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ لأنّ غلبة إستعمال الرفع فيما يكون له وجود سابق لا يقتضي ظهوره في ذلک.[2]
هذا وقد ذهب الإمام الخميني (قدس سرّه) إلى أنّ مفادها هو الرفع وإزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه قائلا :
والتحقيق: أنّه فيه إنّما هو بمعناه الحقيقي، وهو إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه، وذلک لأنّ الرفع إنّما نسب إلى نفس تلک العناوين؛ أي الخطأ والنسيان... إلى آخر التسعة، وهي عناوين متحقّقة قد نسب الرفع إليها إدّعاءً،... ولذلک يجوز نسبة الرفع إلى الموضوع إدّعاءً بواسطة رفع آثاره أو دفعها أو دفع المقتَضي عن التأثير، وذلک لا يوجب أن يكون الرفع المنسوب إلى الموضوع بمعنى الدفع، ولذا
1 ـ وسائل الشيعة :15 369.
2 ـ فوائد الأُصول :3 337.
-
۱۵۷
ترى أنّ تبديل الرفع الدفع يخرج الكلام عن البلاغة، فإذا قيل: دفع النسيان والخطأ إلى غير ذلک، يصير الكلام باردآ مبتَذَلاً.
هذا كلّه إذا نسب الرفع إلى نفس تلک العناوين ادّعاء من غير تقدير في الكلام، كما هو التّحقيق.
ولو سلّمنا بأنّ التقدير رفع الأحكام والآثار أمكن أن يقال أيضآ: أنّه بمعناه الحقيقي لا بمعنى الدفع: أمّا في الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما اضطُرّوا إليه فالأمر واضح؛ لشمول أدلّة الأحكام إطلاقآ أو عموم مواردها، فقولُه تعالى: (السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)[1] و (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[2] يشمل جميع المكلّفين ولو كانوا مُنطبقين للعناوين المذكورة؛ فإنّه بحسب جعل القانون والإرادة الاستعماليّة يشمل الناسي والمخطِئ و المكرَه وغيرهم، وكذلک سائر الأحكام المجعولة في الشريعة، ومفاد الحديث حينئذٍ رفع جميع الآثار، فهو تخصيص لأدلّة الأحكام الأوّليّة المجعولة قانونآ، فإنّ التخصيص والنسخ عبارة عن إنتهاء أمد الحكم.
فدليل الرفع إنّما يرفع الأحكام عنهم، فالرفع إنّما تعلّق بالأحكام الثابتة المتحقّقة في الموضوعات بحسب الإرادة الإستعماليّة... فالرفع إنّما استعمل بإعتبار رفع الحكم القانوني العامّ عن مُنطبَق هذه العناوين، ولا معنى للدفع في هذا المقام.
هذا، وأمّا في الطَّيَرة والحسد والوسوسة في الخلق، فالظاهر أنّ إطلاق الرفع فيها أيضآ بمعناه الحقيقي؛ وذلک لأنّ الظاهر من الحديث الشريف من إختصاص رفع التسعة بالأُمّة المرحومة أنّ لتلک العناوين كانت أحكام في الأُمم السالفة،
1 ـ سورة المائدة: 38.
2 ـ سورة النور: 2.
-
۱۵۸
ومعلوم أنّ الأحكام الصادرة عن الأنبياء المشرّعين لم تكن بحسب الوضع القانوني والإرادة الإستعماليّة مقيّدةً بزمان ومحدودة بحدّ، بل هي أيضآ كانت مجعولةً على العناوين الكلّيّة، مثل (يَا أَيُّهَا النَّاسُ)[1] ونحوه، فكان لها الإطلاق أو العموم بالنسبة إلى جميع الأزمنة، وبهذا الإعتبار يقال: إنّها منسوخة، وإن لم يكن بحسب اللُّبّ نسخ ورفع، بل كان أمدُها وأجلها إلى حدّ محدود، فإذا كان للأحكام المترتّبة على تلک الموضوعات إطلاق أو عموم بالنسبة إلى جميع الأزمنة يكون إستعمال الرفع فيها بمعناه الحقيقي، ولا يكون للدفع معنىً بالنسبة إليها إلّا بحسب اللُّبّ والواقع، وهو ليس مناط صحّة الإستعمالات.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه يأتي بالنسبة إلى جميع العناوين؛ فإنّ الظاهر أنّ لجميعها أحكاماً رُفعت عن هذه الأُمّة إمتناناً، ولو لا ذلک كانت ثابتة لها كالتي قبلها.
فتلخّص كون الرفع بمعناها؛ سواء كان الرفع بلحاظ رفع التسعة بما هي هي، أو كان رفع تلک الأمور حسب الآثار الشرعية.[2]
الجهة الثامنة: كلّية الأدلة الإمتنانية
قد إشتهر بين الأصحاب أنّ أدلة الرفع والحرج ونحوهما ممّا تكون إمتنانية فلايشمل ما لو كان الأمر على خلاف الإمتنان؛ ولهذا قالوا بصحّة الصوم الضرري أو الحرجي إذا أقدم المكلّف عليه.[3]
يقول الشيخ الأعظم(رحمه الله) في الفرائد: واعلم أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد إختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الإمتنان على الأمة كما
1 ـ سورة البقرة: 21.
2 ـ أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية :2 40 41؛ تنقيح الأصول :3 226.
3 ـ كتاب البيع للإمام :1 526.
-
۱۵۹
إذا إستلزم إضرار المسلم؛ فإتلاف المال المحترم نسيانآ أو خطأ لا يرتفع معه الضمان وكذلکالإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم ما إضطروا إليه؛ إذ لا إمتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهية المسوغة لدفع الضرر.[1]
ومن هنا يعتبر المحقّق النائيني(رحمه الله) في التمسک بحديث الرفع أن يكون في رفعه منّة وتوسعة على العباد، فالأثر الّذي يلزم من رفعه التضييق عليهم لا يندرج في عموم الحديث.[2]
هذا، وقد ذهب الإمام الخميني (قدس سرّه) إلى أنّ الإمتنان في الأدلّة الإمتنانيّة إنّما هو الإمتنان على الأُمّة، لا على الشخص، فلا بدّ من لحاظ الإمتنان في القانون، لا الأشخاص والأفراد. والخلط بين الأمرين أوجب إشتباهات كثيرة في كلماتهم، ولذا بنينا على أنّ تحمّل الحرج والإتيان بالمأمور به لا يسقط الأمر. فمعنى حكومة دليل الحرج رفع الحكم الناشئ من جعله الحرج، وفي هذا الرفع إمتنان على الأُمّة، والإمتنان عليهم إقتضى هذا الجعل والقانون، لا الإمتنان الشخصيّ في مورد خاصّ حتّى يقال: الدليل الامتنانيّ لا يشمل مورد خلاف الإمتنان على الغير، أو الإمتنان يقتضي المعذوريّة، لا عدم المشروعيّة.[3]
يقول الإمام الخميني (قدس سرّه) في كتاب البيع :
إنّ الأحكام الإمتنانيّة إنّما هي إمتنانيّة بحسب القانون الكلّي، ولا يلاحظ فيه آحاد المكلّفين، فإذا كان في جعل قانون إمتنان على الأُمّة، كان الحكم إمتنانيّآ، وإن فرض مصادمته في موردٍ لشخص أو أشخاص، وكونه موجبآ لحرمانهم عن
1 ـ فرائد الأصول :2 35.
2 ـ نفس المصدر :3 348.
3 ـ كتاب البيع (تقريرات لآية الله القديري): 275.
-
۱۶۰
حقّ أو ملک؛ كما أنّ المصالح والمفاسد في الأحكام على رأي العدليّة ليست بمعنى كون الحكم بالنسبة إلى كلّ أحد ذا مصلحة وكما في الأحكام السياسيّة والجزائيّة، فإنّها أحكام إمتنانيّة على الأُمّة، وإن كان فيها ضرر وحرج على الجاني. فحديث الرفع إمتناني، مع أنّ جواز أكل مال الغير عند الإضطرار بلا إذنصاحبه أو مع نهيه، خلاف المنّة بالنسبة إليه، وهذا لا ينافي الإمتنان بحسب القانون.[1]
وقد أضاف إليه ولده الشهيد مصطفى(رحمه الله) :
بأنّه بناءً على القول بعدم إنحفاظ الخطابات الكلية القانونية بالنسبة إلى حال الجهل والسهو والنسيان، لا يمكن تصوير الأحكام الفعلية بالنسبة إليهم، فيلزم منه لغوية حديث الرفع، وعدم الحاجة إليه؛ ضرورة أنّ مع عدم وجود التكليف ثبوتآ لا معنى لذلک قطعآ؛ وإن قلنا بأنّ الخطابات العامة القانونية تستتبع الأحكام الفعلية بالنسبة إلى الكلّ على حد سواء، فيكون المنّة في نفس الرفع المستند إلى «ما لا يعلمون...»[2] وأما على مذهبهم من صرف تلک القوانين العامة عن ظواهرها، فلا بدّ من أن يكون الرفع بلحاظ الشمول الإنشائيّ، ويكون دفعآ حقيقةً، وهذا واضح المنع، للزوم التفكيک في الإسناد الواحد عرفا.
ولعمري، إنّ الأصحاب لعدم تمكّنهم من تصوير الحكم الفعلي في هذه الموارد، إرتكبوا ما إرتكبوا فقالوا: «إنّ الإمتنان بلحاظ إمكان التضييق من ناحية جعل التكليف الآخر، أو الإحتياط والتحفظ» وأنت خبير بما فيه من ظهور الغرابة، فإنّ الحديث ناظر إلى أنّ رفع ما لا يعلمون منّةً، لا الأمر الآخر الأجنبي. وبالجملة: لا يلزم من الجمع بين حديث الرفع والقوانين الكلية، إختصاص
1 ـ كتاب البيع للإمام الخميني :1 526 527.
2 ـ وسائل الشيعة :15 369.